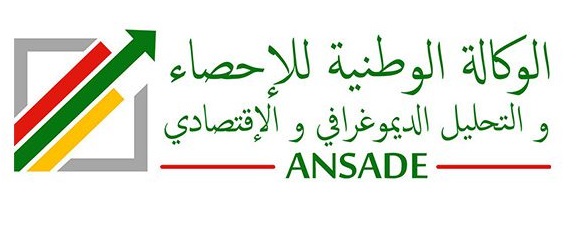لعنف هو العنف سواء قام به المسلمون أو اليهود أو المسيحيون أو الكهنة البوذيون. العنف هو العنف، سواء قام به الأمريكان أو العرب أو الأوروبيون أو الروس أو الهنود أو غيرهم.
أن يحرق طيار أردني، أو يذبح صحافي ياباني، أو ناشط أمريكي، فالجريمة واحدة، وكان يجب التعامل معها بردة الفعل نفسها، لأن ما حدث فعلا هو أننا لا نبالي حين تكون الضحية من غير ديننا وملّتنا. أغلبنا يجد مبررات للعنف الذي تمارسه الجماعات، لأننا في كل مرة ننسبه لفئة، فمرة أمريكا كونته، وهذا يعني أننا بشكل ما نبرئ أنفسنا، ومرة ينسب لطائفة معينة، ومرة لدول الجوار، ومرة للأنظمة… في كل مرة نجد التبريرات للعنف، ولأننا كذلك فقد أصبح من السهل أن يضحك علينا بطريقة غريبة لتقبل العنف وممارسته.
أن تحرق جان دارك حية ثم تطوّب قديسة بعد قرنين من حرقها، ليس سوى نوع من الاعتذار المتأخر لمجتمع مارس كل أنواع العنف ضد نفسه. فأوروبا الرّاقية في أعيننا لم تكن سوى مجموعة من الشعوب المسعورة التي ذبحت بعضها بعضا حتى أنهكها القتال. مؤسس علم الكيمياء في تاريخ العلوم الحديثة، أنطوان دي لافوازييه، قطع رأسه بالمقصلة، هو وتلاميذه، والقاضي الذي حكم عليه بهذا الحكم الوحشي قال له «الجمهورية ليست بحاجة لعلماء»، وهذا في قمة الثورة الفرنسية.. دائرة العنف هي ذاتها، تاريخنا دموي؟ نعرف ذلك، لكننا نعرف أيضا، أن الإنسان كائن عنيف، والوحيد الذي يحب تصفية أبناء سلالته من أجل مكاسب دنيوية لا تدوم.
تفتح أمريكا حروبا مختلفة في بؤر كثيرة من العالم، لتقضي على الإرهاب أو تنشر الديمقراطية، فهل يمكن القضاء على الإرهاب بالعنف، ما دمنا نعرف أن العنف يوّلد العنف؟
تقصف بلداننا، تقتل الأبرياء والمجرمين بالطريقة نفسها، تتلفهم كما يتلف الجراد، فهل يمكن لدائرة العنف أن تبقى حيزا مكانها؟ وهل يمكن للكراهية أن تظل تحت مظلة الإرهاب فقط؟
منذ سنوات كانت كلمة إرهاب ممنوعة في الإعلام العربي، وكان كل ما هو متطرّف، خاصة إن حمل راية الدين، يوصف بأوصاف أكثر رأفة، وكأن مشاعر القتلة قد تتغير إن غيرنا التسمية الملصقة بهم…
كانت الأنظمة أيضا تتدخل لترغم الإعلامي على قول الأشياء على غير حقيقتها، بعض الدول موّلت هذه الجماعات بمباركة شيوخ قادوا دفة الإفتاء. وحين أصبح الوباء اليوم يكتسح عالمنا الإسلامي ولم يعد يفرق بين الصالح والطالح، قرعت أجراس الخطر، حتى أن بعض شيوخ الفضائيات غيروا من حدة خطابهم، والبعض الآخر ارتدى عباءة الاعتدال بشكل لافت.
والسؤال الذي يجب طرحه الآن هو: هل يمكن أن نستعيد أنفسنا إن بلغنا مرحلة «التّوحُّش» وشهوة الدماء وسعار الاقتتال؟ هل يمكن لأفغانستان أن تنهض من نكبتها ونرى فيها حياة طبيعية؟ هل يمكن للشام أن تستعيد روحها المسالمة؟ وتاريخها الذي مسح مسحا حتى من رؤوس أبنائها؟ هل يمكن لأي بقعة في الأرض اليوم تؤثثها الحروب والدماء والجثث الآسنة أن تستعيد شهوة الحياة بدل اشتهاء الدماء وكأننا جميعا أحفاد لدراكولا؟ هل يمكن أن نوقف كرة الكراهية التي تكبر مثل كرة الثلج وشارفت اليوم على تدميرنا جميعا، لأن حجمها لم يعد صغيرا كما حين بدأت بالتدحرج بعيدا عنا؟
نطرح الأسئلة ونحن نعرف جيدا أن الجواب الوحيد لإيقاف كرة الكراهية هو أن نتوقف عن ممارسة الأحقاد تجاه بعضنا بعضا. علينا أن نأخذ قرارا كمن يأخذ قرارا ببدء ريجيم لمعالجة نفسه، أو بالتوقف عن التدخين لأنه بلغ عتبة قتل نفسه. بالطبع ليس سهلا أن نغسل قلوبنا حتى من الأحقاد الصّغيرة التي لوثت قلوبنا منذ كنا أطفالا، لكن من السّهل أن نبدأ بحب أنفسنا أولا، وأولادنا، ومن حولنا ونفكر في الحفاظ على سلامتهم وبقائهم أحياء وسعداء حولنا.
فدائرة العنف تبدأ حين نربي أولادنا بالعصا والتعنيف اللفظي بدل أن نربيهم بالكلمة.
لا شيء أسوأ من أن نلقن أولادنا درسا في العنف، من دون أن ننتبه حتى أنه درس سيبقى طيلة حياته في رأسه وقد يأخذ أبعادا خطيرة حين تغذيه عوامل خارجية أخرى يحتك بها كل يوم.
يقول الطب النفسي إن الآباء الذين يصرخون، سيجعلون أولادهم يصرخون، وإن لم ينجح الصراخ للحصول على ما يريدون ينتقلون لمرحلة أخرى، قد تكون الدخول في نوبة غضب عارمة قد تنتهي بممارسة العنف ضد أنفسهم أو ضد الآخرين. الأطفال الذين يبكون بسهولة بعد الخامسة أطفال يرون أمهاتهم يبكين كثيرا، يلجأون لاستعطاف الآخر بالبكاء، لهذا وجب على الأم أن تعرف متى تبكي وأين. صحيح أن العائلات عندنا تبنى على علاقات زائفة بعيدة عن روابط الحب القوية والرّغبة حتى في الحصول على أولاد، لكن من السّهل أن نغيّر قليلا في سلوكنا أمام أولادنا.
تحكي لي صديقتي عن أحد أصدقاء ابنها، أنها سألته ما اسم والدك؟ فأجابها: اسمه سعيد، لكنه لم يعد «سعيدا» الآن…فسألته: أوووه هل غيّر اسمه؟ فقال لها مازحا: لا، لكن منذ أنجبنا لم يعد سعيدا..! حين ضحكت عند سماع القصة، لم أنتبه إلى أنني أضحك لأن الطفل صاغ قصته المأساوية بشكل كوميدي، فليس أسوأ من أن يشعر الطفل أن والديه حزينان لأنهما أنجباه، أو أنه خيبة أملهما في الحياة. سيظل هذا الشعور بالذنب يلاحقه إلى أن يبني عائلة هو الآخر، مرغما لا بطلا، يذهب نحو حتفه من دون قناعة تسكنه أنه لن يكون سعيدا بإنجاب أطفاله. كرة عنف معنوي أخرى تكبر في ذاته، خليط بين الشعور بالذنب والشعور بلاجدوى الحياة، خليط يشبه مكونات قنبلة موقوتة، تنفجر حين يحين أوانها… وهذا ما يسمى ترسبات العنف فينا.
بعضكم سيقول إنني كاتبة، ولا علاقة لي بعلم النفس، وإن ما أقوله «هراء» مثل كل الهراء الذي يكتبه الكُتّاب. لكنني سأشرح أيضا، أننا لو تربينا على قراءة الكتب منذ كنا أطفالا، وكان الكتاب رفيقنا منذ الطفولة لما كبرت كرة الجهل في داخلنا، وتحوّلنا إلى كائنات تحارب المعرفة بأسلحة متنوعة تبدأ بالسخرية بالكُتّاب وتنتهي بمحاولة تدمير الكاتب نفسه بجعله خارج دائرة اهتماماتنا وتهميشه وقد يبلغ البعض درجة الاعتداء عليه لفظيا وجسديا. كم كاتبا اعتدي عليه في مجتمعاتنا على اختلافها؟ كم كاتبا اغتيل برصاص الإرهاب؟ كم كاتبا تشرّد في المنافي بسبب محاربة أفكاره. كم كاتبا يقرأ هذه السطور ويقول في صمت «صح…صح» ولكنه يشعر بالعجز على تغيير واقعنا البائس؟
أجزم أن عنف مجتمعنا بدأ من العائلة، وتربية الأطفال بطريقة غلط، لهذا أطلب من كل شخص يبتسم الآن على أنني «خرفانة» في نظره وأنه يفهم أكثر مني فليسأل مختصا ويفيدنا برأيه؟ أو ليقم ببحث علمي في الموضوع ويناقشني، فقد أكون مخطئة وقد يكون هو الصح، لكن عليه إثبات ذلك بدل الاكتفاء بالضحك والسخرية من كل ما يكتب من دون تقديم دليل. نعم أكون سعيدة إن غلّطني أحدهم وقدم أدلّة على أنني مخطئة… فقط عليه بالمحاولة للرد عليّ بالكلمة. فقط عليه أن يوقف دحرجة كرة الكراهية والعنف لأنها تبدأ من هنا.
وللحديث بقية إن شاء الله.
كاتبة بحرينية
بروين حبيب