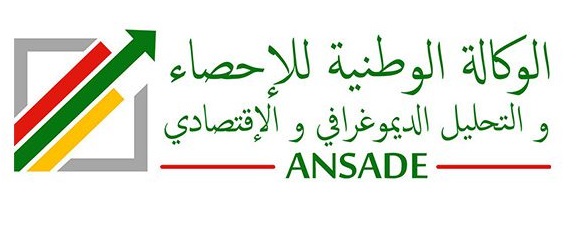يريد البعض أننا دولة ديمقراطية تتنافس فيها الأحزاب على ضوء البرامج البناءة وخلفية الخطابات السياسية التوجيهية النيرة والرؤى الاستشرافية البارزة المعالم المحبكة التفاصيل والآخذة بوسائل التنفيذ العلمية والفنية، ثم ينسى أن الحال في حقيقة الأمر غير ذلك حيث أن الواقع القابع وراء المظهر يشي بتدثره بمفاهيم وعقلية ماضي اللادولة مما يجعله أبعد ما يكون عن الديمقراطية ونبل مقاصدها. و لكن الأدهى والأمر من هذا كله يبقى تقهقر الطبقة المثقفة في البلد و التي من المعلوم أنها في كل تجارب غيره من البلدان الديمقراطية عولت عليها في المرتبة الأولى و اعتمد عليها في المرحلة الموالية لتحقيقها و ترسيخها و ضمان استمرارها.
و لا شك من هنا أن القبول بالحاصل من استشراء “الظلم الصامت” في كل مفاصل حراك البلد هو عادة مكتسبة تعودنا قبولها حتى بات دولة بيننا بطرق و أشكال أصبحت هي بالتالي جزء مكينا من الطبع العام و التعامل الاعتيادي لا تحارب و لا تصادر. و إن المتتبع لتاريخ موريتانيا منذ الاستقلال لا بد أن يقف على حقيقتين ما زالتا توجهان سياق حكم البلد و معاملة الأنظمة مع الشأنين الشعبي و “الحكاماتي” إن جاز التعبير.
و أما الأمر الأول فتداول الأنظمة اعتبار الإنتماء القبلي لرأس الحكم ـ مدنيا كان أو عسكريا ـ حيث أنه سيتحرك آليا عاجلا أم آجلا بحسب ما تسمح به الظروف في السياق القبلي الذي سيدفعه إلى واجهة الصدارة. و لو أنه لا يجوز الإعلان عن ذلك فإن الوسط الشعبي بقدرته التأويلية الموروثة من عقلية منطق القوة و الضعف لدى المجتمع في بنيته الترابية التفاضلية هو الذي سيسهل للقبيلة و أحلافها و جهاتها و مستويات التمثيل فيها أن تأخذ زمام الأمور عند أول وهلة مع الإحساس الجديد بالمكانة المكتسبة و من خلال خلاياها و نوايا التشاور فيها لتقيم في السياق العام لحراك الدولة منطقها القبلي الجهوي التحالفي حتى يتصدر المرحلة التسييرية لفترة قيام الحكم بأيديها و استتباب الأمر لها.
و لما كانت قبائل قد استطاعت أن تدير اللعبة لفترات طويلة فإن أخرى أخفقت في المد الزمني و إن لم تفوت الفرصة لتنجز لنفسها في المد “الحكاماتي” مثلما عملت الأخريات. و إن المتفحص بإمعان لهذه الفترات لا بد أن يلحظ بصمات الظهور الطافح في صياغة القرار و تدبير الشأن المالي و التوظيفي و التسييري و التوجيهي للسياسات العامة و الخاصة.
و بالطبع فإنه لم ينقض حكم على يد آخر إلا و كان ترك قبل الانزياح بصمات الزعامة التقليدية و الأسر الأرستقراطية و التجار و الطبقة المتعلمة للقبلية و أقرب الحلفاء واضحة للعيان في التموقع داخل الهياكل الإدارية و الفنية للدولة من ناحية، و في الحركة الاقتصادية من خلال عدد الشركات الخدمية و المكاتب الدراسية و المصحات و المدارس التعليمية الخصوصية و العقار الزراعي و السكني المنتج، حتى باتت الأحياء و المصحات و المدارس و المكاتب و الأسواق التي رأت النور خلال تعاقب الأنظمة تتسمى بالقبائل و لوبيات الأحكام المتتالية في إقصاء مرير لأغلب المواطنين و تكريس مشين لمفاهيم تتنافى مع قيم و مرامي دولة المواطنة و القانون.
و بالطبع أيضا أنه قد تولد عن هذه الوضعية عجز البلد الدائم عن أخذ ملامح الحداثة و دفع عجلة التنمية الشاملة التي ارتهنت على الدوام وسائلها و مداخل مواردها الهائلة لتكريس ظلم البعض القليل للأغلبية الساحقة من المواطنين من الدرجة الثانية في سياقات التهميش القسري المعمول به كنظام مكرس منذ الاستقلال و في طياته استمرار غير منكتم لمنطق الماضي.
و أما الأمر الثاني فهو أن ارتهان مفاهيم و قيم الجمهورية كذلك، لسطوة الماضي/الحاضر السيباتي-الرجعي-الإقطاعي و ضعف و اختلال واقع الحال، شكل حائلا دون الالتحام بمضامين الحداثة و استخدام وسائله لبناء الذات الوطنية الخالصة للبناء و المدنية. و ليس غريبا بهذا الانحسار المتعمد أن العمل السياسي ينهج ذات التوجه رغم التغطية الساذجة و الفاشلة على ذلك، و لا أن تُرى التحالفاتُ تنقلب رأسا على عقب على إثر كل مسار انقلابي يحدث من دون أن “تنكسر الجرة” أو “تنطح شاة شاة”، ثم لا يمضي وقت طويل حتى تُشاهد التحالفات و قد تبادلت الأدوار و هي تعمل معا على دهس البلد و تبديد مقدراته و ظلم مواطنيه. و لا يفوت في هذا لسياق أن المهنئين الأول على عتبة الحكام الجدد هم بدون خجل من أزيحوا للتو؛ مَقدم لا يقبل التأخير لسد متعَّمد للباب أمام التَّغيير.
و إن أمكن لسبب أو لآخر استثناء بعض الأحزاب القليلة التي تحمل ضمن مبررات تأسيسها ما يشفع لوجودها بشكل أو بآخر، فإن الجميع في هذه التشكيلات لا يُستثنى في تعويله سرا أ علانية على انتمائه القبلي أو الجغرافي للحصول على نصيب مادي من المال العام أو الوظيفة أو الجاه المُنتج.
و لإنه لم يحصل تغيير جوهري في العقلية المتخلفة السائدة و المهيمنة رغم التعلم بأعلى المستويات و الدرجات و مرور أكثر من نصف قرن من الدولة إسما و حيزا ترابيا و من الدساتير و المواثيق فإن الخشية تُصبح أن لا تتهيأ الأمورُ مطلقا لكسب أسباب التدبير العقلانيّ لسلطة “المواطنة” و”الخدمية” القادرة على تجاوز كل الشوائب و الاختلالات المتربصة، و أن يستحيل رسم معالم سلطة الغد المتجددة والمجددة التي تتوخى ربح رهان الحكامة الرشيدة و الديمقراطية